وصلتُ إلى دكانه الصغير. كان عجوزًا يلف رأسَه بعمامةٍ بيضاء، ويحتفظ بخدين موردين يُوحيان أن له أصلًا تركيًا. ظل محنيًا وراء ماكينة خياطة عتيقة تصدر تكتكة، بينما هو يحدثني بجملٍ قليلة، وأنا صامتٌ في حضرته.
ليس هناك زحام لزبائن، لكنه اعتاد أن يشغلَ فراغ أيامه برتق ملابس الفلاحين، هنا وهناك تناثرت جلابيب وسروايل داخلية وصُدر. لا أفهم كيف يستمرُ العجوزُ في مهنته رغم شح بصره!
ولا أعرفُ كيف جمعت بيننا محبة. فلا صلة قرابة مباشرة ولا أنا ألبس ملابس الفلاحين هذه. ربما أرسلني أحد أقاربي لجلب صديري كان يرتقه الشيخ له.
تكررت زياراتي إلى دكانه شبه المعتم بلا سبب معين، سوى الراحة القلبية. لم يخبرني أنه حج إلى بيت الله ولا أتذكر أننا التقينا أثناء صلاة في مسجدنا الكبير. أحيانًا كان يحدثني عن أفكار قرأها هنا وهناك.
وأحيانا كنتُ أراه ـ من بعيد ـ جالسًا على المقهى يراقب لعب الآخرين للدومينو وهو مبتسم وعلى رأسه عمامة خضراء كبيرة. كنت أراه وسيمًا باستدارة وجهه واحمرار خديه، وتلك البشاشة الروحية التي تشعُ من هيئته كلها.

في طفولتي كنتُ أتصور الأنبياء والأولياء على هيئة الفلاحين الطيبين الذين أميز وجوههم الكادحة. وكنتُ أظن أن الشيخ محمود الخياط البسيط، الخجول المبتسم، ذا العمامة الخضراء، يشبه وليًا من الأولياء الصالحين في قديم الزمان. ولربما كان هو نفسه وليًا ولا يعرف أو يعرف ولا يُعلن.
كنتُ في المرحلة الإعدادية، ولم أتخيل أن الشيخ محمود الخياط العجوز مثقف اعتاد أن يقرأ مجلات الأزهر والرسالة. وعندما علم أنني أحب الكتابة لم يقل لي: “اهتم بمذاكرتك”، بل شجعني وتوقع أن يكون لي شأن في المستقبل.
لا أدري أية فراسة جعلتُه يتوقع ذلك! ولا أنسى عندما كان في مكتب البريد وعلم أن هناك خطابا باسمي فأصر أن يأتيني به، رغم أن بيتنا في آخر القرية، ما يعني أنه سوف يسير مسافة ليست هينة على عكازه.
غمرني حنان نظراته وأنا أفتح الخطاب بهدوء بينما كان يحدثني بلهفة: “بشرني”! أظنه كان خطابًا روتينياً جدًا، ووجدتني في حرج كي لا أكسر بخاطره وتوقعه أنه خطاب فوز بجائزة ما، عن قصةٍ لم أكتبها.
إن الأمر قريب
تباعدتْ بيننا أيام وشهور وسنوات، مع استقراري في القاهرة ثم مرحلة الجيش، ثم سفري إلى الكويت. ولا أتذكر أنني سمعت خبر وفاته ولا حضرت له جنازة. فجأة اختفى من مساري مستبقيًا ابتسامته وعمامته الخضراء. بعد سنوات حلمتُ به حلماً قصيرًا جدًا، كان واقفًا فوق صخرة في عرض البحر لا تطوله الأمواج، بينما أنا على الشاطئ أسمع صوته يهتف لي: “إن الأمر قريب. إن الأمر قريب”.
بعد عودتي من الكويت، وأثناء زيارتي إلى قريتنا، روى لي صديق عزيز أكبر مني سنًا، أن إحدى بنات الشيخ رأته -بعد وفاته- كان يقف أمامها حيًا. ليس شبحًا ولا وهمًا ولا حلمًا. هل هو حقًا حي لم يمت؟ هل يملك خاصية تجعله قابلًا للحضور كيفما يشاء وقتما يشاء؟ هل يستطيع -في عالمه الآخر- أن يتابع أخباري السعيدة، والحزينة أيضًا؟
في طفولتي كنتُ أتصور الأنبياء والأولياء على هيئة الفلاحين الطيبين الذين أميز وجوههم الكادحة. وكنتُ أظن أن الشيخ محمود الخياط البسيط، الخجول المبتسم، ذا العمامة الخضراء، يشبه وليًا من الأولياء الصالحين في قديم الزمان. ولربما كان هو نفسه وليًا ولا يعرف أو يعرف ولا يُعلن.
كيف تتأتى الولاية لبعضِ البشر دون غيرهم؟
روى أحدهم عن الفضيل بن عياض أنه كان جالسًا بين أصحابه فقال: لو أن الرجل صدق في التوكل على الله عز وجل، ثم قال لهذا الجبل: اهتزْ لاهتز.. فوالله لقد رأيتُ الجبل قد اهتز وتحرك، فقال الفضيل: يا هذا إني لم أعنك رحمك الله، قال: فسكن.
الغريب أن الفضيل الذي استجاب له الجبل واهتز لم يكن في مبتدأ حياته عالمًا ورعًا بل كان لصًا قاطع طريق، وسبب توبته أنه عشق جارية، وبينما كان يرتقي الجدران إليها، سمع من يتلو “ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله” فقال: بلى يا رب، قد آن، وجعل توبته مجاورة بيت الله الحرام.
كيف ينقلب فجأة قاطعُ طريقٍ إلى ولي الله؟ بينما لا يصل نُساك على مدى سنوات إلى تلك المكانة؟

هو الولي
يشير فعل “ولي” إلى معاني: دنا ولزم، ونصر، وأحب. فالولي هو من يلزم جوار الله وكلمته، وينصره مجاهدًا في سبيله وأول المجاهدة جهاد النفس، والولي يحب الله ولا يشرك في محبته أحدًا. إن الفعل “لزم” يشير إلى الإيمان، و”النصر والتأييد” إلى السلوك البادي، بينما فعل “الحب” يقود إلى كل ما هو قلبي خفي عن الأعين.
يتماهى “الولي” بتلك الصفة الربانية مع اسم من أسماء الله الحسني، فسبحانه وتعالي هو الولي، يتولى عباده بلطفه وتدبيره، بينما يتولاه عباده بالطاعة والتقرب إليه.
فيصبح الولي وليًا عنه بالإنابة؛ متصرفًا باسمه، يهبه الله من قدرته ما يشاء، ويجري على يديه كرامات، ويبصره غيبًا لا يطلع عليه أحدًا من خلقه.
لا يتأله الولي بل يغدو في معية الألوهية، وسَننها، لا في معية البشر وسننهم. وإما أن يكون المعنى صيغة مبالغة على وزن فعيل كالعليم والقدير، أي من توالت طاعته دون أن تتخللها معصية، أو على وزن فعيل بمعنى مفعول مثل جريح والمقصود “مجروح”، أي أن الله يتولى حفظه وحراسته من كل أنواع المعاصي، ويديم توفيقه على طاعته. (جامع الكرامات للنبهاني، ص7). كأن الولاية ثمرة جهد وإرادة صاحبها من جهة، وفضل وكرم الله من جهة أخرى، فلا تعارض بين المعنيين.
فقد تكون الولاية عطية واجتباء “الله يجتبي إليه من يشاء” (الشورى: 13)، وقد تكون نتيجة إيمان وتقوى وصلاح وكفاية ذاتية وتعبدية، تجعل العبد أهلًا للتبليغ، ووراثة النبوة (أبحدية التصوف، ص 36).

طرق المعرفة
وهنا يفرق بعض الباحثين بين ثلاثة طرق للمعرفة إما بالحس (التجريب اعتمادًا على الحواس) أو بالعقل (بدهيات منطقية) أو بالحدس. ولا خلاف بين البشر على الطريقتين الأوليين، وإنما الخلاف على الثالثة التي يعتمد عليها المتصوفة، إذ يصبح اكتساب العلم عرفانيًا لدنيًا، بالمكاشفة والبصيرة.
أي أن الولى يملك حدسًا رحبًا يجعله بحرًا فيما نعلم وما لا نعلم، بما في ذلك فتح أبواب الغيب له -بإذن الله- ومشاهدة كائنات لا تُرى بأعين البشر، كالجن والملائكة. ثم ينتقل من قوة المعرفة إلى امتلاك إرادة التغيير في مجريات الأمور وأقدار الناس، فقد بات ربانيًا يقول للشيء كن فيكون.
وبسبب الحدس وعرفانية العلم، وديمومة الاتصال بالله تعالى، فرق بعضهم بين الولاية والنبوة، باعتبار الأولى تلقيًا مباشرًا عن الله، بينما النبوة ملزمة بالوحي عن طريق ملك. ما قد يُفهم أن الولاية تفوق النبوة مكانة. فليس غريبًا أن ينقل الشعراني عن الشاذلي قوله: “لا إنكار على من قال: كلمني الله كما كلم موسى”. ويقول ابن عجيبة الحسني: “إن الحق سبحانه قسم الخلق قسمين وفرقهم فرقتين: قسم اختصهم بمحبته، وجعلهم من أهل ولايته، ففتح لهم الباب، وكشف لهم الحجاب، فأشهدهم أسرار ذاته، ولم يحجبهم عنه بآثار قدرته”. (التصوف: المنشأ والمصادر، ص175، و177).
فالولي الحق يجمع بين علم الشريعة (الظاهر) وعلم الحقيقة (الباطن)، ومهما أوتي من علم، وقدرة، فإنه يعيش عيشة الكفاف، وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا، فخرجوا عن الأوطان، وهجروا الأخدان، وساحوا في البلاد، وأجاعوا الأكباد، وأعروا الأجساد، لم يأخذوا من الدنيا إلا ما لا يجوز تركه، من ستر عورة، وسد جوعة (التصوف: المنشأ والمصادر، ص21).
علامة العارف
وما بين المغالاة في نسبة الكرامات إليهم، والدنو والتماهي مع الذات الإلهية، وإظهار الذات وإخفائها، وتجاذبها ما بين الشريعة والحقيقة (الظاهر والباطن)، والتمتع بالنعم والزهد فيها، يلخص ذو النون المصري علامات العارف (الولي) قائلًا: “علامة العارف ثلاثة؛ لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنًا من العلم ينقض عليه ظاهرًا، ولا يحمله كثرة نعم الله ـ تعالى ـ عليه وكرامته على هتك أستار محارم الله تعالى” .(الولاية في التراث الصوفي، ص71).
بينما تقول ميمونة ـ زوج إبراهيم بن أدهم: “قلوب العارفين لها عيون.. ترى ما لا يراه الناظرون”.
فأنت على طريق الولاية، طالما كنت ترى الله بقلبك كله خوفًا ومحبة، وتوقن، أن الله يراك. أما الوصول فغير مأمون لأحد.
 شهرزاد
شهرزاد



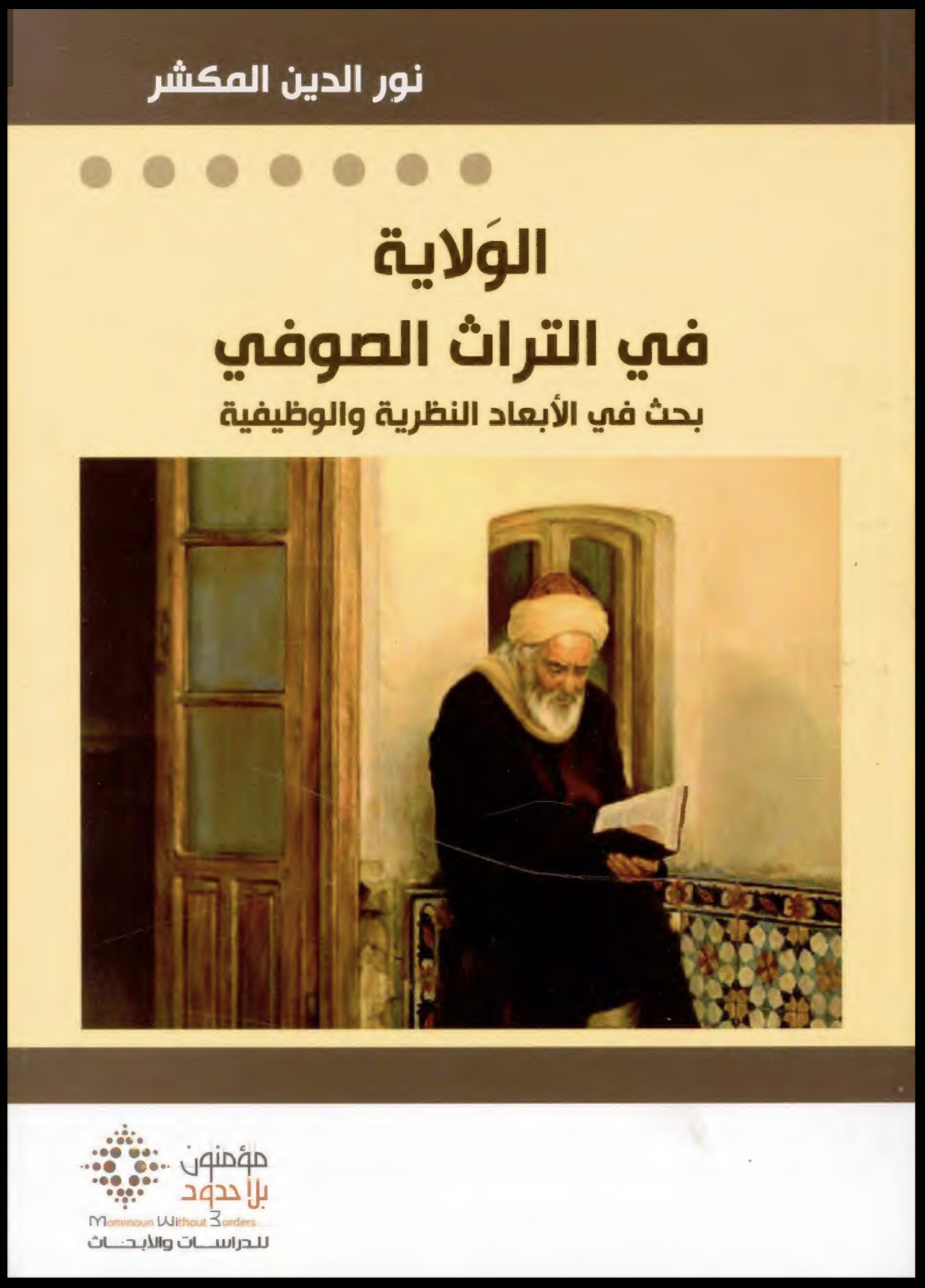
هكذا يدهشنا دوما شريف صالح بالسرد الممتع الفياض كما فيض العارفين الذين تحدث عنهم.